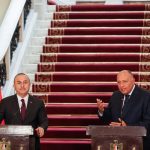بدأ المغرب بإطلاق مبادرات لربط شرقه المهمل بالاقتصاد المحلي والعالمي، لكن من المهم ضمان استثمار المكاسب التي تحققها هذه المبادرات بشكل منصف في المجتمعات المحلية.
تتضاءل أهمية الحدود المغربية الجزائرية، وعلى وجه الخصوص لجهة تأثيرها الاقتصادي على المغاربة الذين يعيشون بالقرب منها.
ويُعزى السبب الأساسي لهذا التطور إلى أن الحكومة سعت، خلال السنوات القليلة الماضية إلى الحدّ من اعتماد مناطقها الحدودية الشرقية على التجارة عبر الحدود مع الجزائر.
وقد تمحورت جهود الرباط حول ربط المناطق الحدودية الشرقية النائية سابقًا بالمراكز الاقتصادية للبلاد، وتزويد سكانها بالوسائل اللازمة لتوليد الإيرادات محليًا.
علاوةً على ذلك، دفعت التوترات المتنامية بين الجزائر والمغرب على مدى العامَين الماضيَين الرباط إلى دمج المناطق الحدودية الشرقية في الاقتصاد الوطني.
مع ذلك، لا يخلو مشروع دمج المناطق الحدودية الشرقية بسائر البلاد من التحديات، ولا يبدو واضحًا على الدوام المسار الذي ستسلكه الرباط في مواجهة هذه التحديات.
أولًا، لا يمكن للمغرب تغيير موقعه الجغرافي. وعليه، غالبًا ما تؤدي التوترات السياسية مع الجزائر إلى التشدّد في ضبط أمن الحدود، بحيث تظل مجتمعات الجهة الشرقية في المغرب عرضة للتأثُّر جزئيًا بالتقلبات الجيوسياسية.
ثانيًا، تؤدي عملية التصنيع في المناطق الأكثر فقرًا، في الكثير من الأحيان، إلى توزيع مجحف للثروة والموارد، ما يسبب احتكاكات اجتماعية، وحتى بروز نظام طبقي جديد.
وفي حال حدوث ذلك في المناطق الحدودية الشرقية للمغرب، ستُستبدل المشكلة القديمة بأخرى جديدة.
أخيرًا، سبق أن بدأ تغيّر المناخ وما يصاحبه من تصحر يؤثران على هذه المناطق، ولا سيما الجزء الجنوبي منها، ومن المرجح على ما يبدو أن تتسارع وتيرة هذه التأثيرات مع مرور الوقت.
تكوين الحدود وتضاؤل تأثيرها مؤخرًا
يعكس مسار الدولة المغربية الحديثة التأثير المتراجع للحدود مع الجزائر على المناطق الحدودية المغربية، ولفهم ما حصل، لا بدّ من البدء بتفحّص كيف استحقت المناطق الحدودية الشرقية مثل هذا التصنيف.
لقد مهدّت معاهدة لالة مغنية في العام 1845 الطريق أمام رسم حدود برية تفصل بين المغرب والجزائر.
لكن الترسيم الفعلي للحدود حصل في فترة ما بعد الاستقلال، وعلى الرغم من بروز المغرب والجزائر كدولتَين مستقلتَين، بقيت المناطق على جانبَي الحدود مرتبطة ببعضها البعض عبر صلات القرابة والعلاقات التجارية.
الجدير بالذكر أن معظم الأنشطة الاقتصادية تركّزت في المدن الحدودية كوجدة في المغرب، ومغنية وتلمسان في الجزائر.
أظهرت الحكومات المغربية المتعاقبة وعيًا وحتى حساسية تجاه الضروريات الاقتصادية للمناطق الحدودية الشرقية.
لكن في العام 1996، لجأت الحكومة المغربية إلى إصلاح اقتصاد البلاد وهيكلياتها السياسية، ما من شأنه أن يكون له أثر مباشر على المناطق الحدودية الشرقية.
وتجلّى هذا الميل نحو الإصلاح في بادئ الأمر خلال سبعينيات القرن الماضي، عقب انقلابَين فاشليَن وتسجيل عجز مالي كبير ناجم عن هبوط أسعار الفوسفات واختلال التوازن بين الاستيراد والتصدير بشكل متزايد.
وفي حين حاولت الدولة في البداية ايجاد حلّ للمشكلة من خلال برنامج وطني لإساء الاستقرار المالي، دفعت الاضطرابات السياسية، التي اندلعت في الثمانينيات وعُرفت باسم “انتفاضة الخبز”، بالدولة إلى تبنّي سلسلة من برامج التعديل البنيوي وسياسات التحرير الاقتصادي الضرورية لتأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وخلال العامَين 1996 و1997، أشرفت حكومة ائتلافية، عُرفت باسم “حكومة التناوب” بقيادة حزب المعارضة الرئيس في البلاد آنذاك، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على سلسلة من التعديلات الدستورية، سمح عدد كبير منها بانفتاح سياسي تدريجي، شمل تأسيس مجلس نواب يُنتخب بالاقتراع العام المباشر.
وأطلقت أيضًا تغييرات اقتصادية، حفزتها في آن واحد المطالب الدولية والديناميكيات المحلية على غرار التمدين السريع، وبدأت في إضعاف الانقسام القوي بين المركز والأطراف الذي طبع المغرب لفترة طويلة.
وتجلّى ذلك بإطلاق المبادرة الملكية لتنمية الجهة الشرقية في المغرب في العام 2003، وهو مشروع يهدف إلى دمج الجهة الشرقية المهملة في الاقتصاد الوطني.
وأدّى تشديد القبضة الأمنية على الحدود والتأثير السلبي لتفشي وباء فيروس كورونا على معيشة الناس إلى تسريع هذه العملية.
تشكّل التجمعات الساحلية في الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا-القنيطرة المركز الاقتصادي للمغرب. وفقًا للمندوبية السامية للتخطيط، وهي معهد إحصاءات تديره الحكومة، شكّلت جهتَي الدار البيضاء -سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة معًا نسبة 58 في المئة من ثروة البلاد في العام 2019، بالمقارنة مع الجهة الشرقية التي ساهمت بنسبة 5.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي الوطني.
قد لا تكون معدلات البطالة متباينة إلى هذه الدرجة، لكنها على الرغم من ذلك مثيرة للقلق. في العام 2019، كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تسجيل البطالة نسبة 13.8 في المئة شرق البلاد، وشكّل ذلك ثاني أعلى معدل في المغرب، حيث بلغ المتوسط في جميع الجهات 9.2 في المئة. وعلى مدى عقود، أدّى تركّز الصناعة والتجارة وفرص العمل على طول الساحل إلى استمرار موجة النزوح الريفي من المناطق الحدودية المهمشة، بحيث يشقّ معظم النازحين طريقهم إلى المدن الساحلية.
رأت الحكومة المغربية ربط الشرق بالمراكز الاقتصادية، ولا سيما جهات الدار البيضاء-سطات وطنجة-تطوان-الحسيمة، والرباط-سلا–القنيطرة، أساسيًا لتعزيز قدرة المنطقة على جذب هذا النوع من المشاريع الاستثمارية الكبرى الضرورية لتحفيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولعبت المبادرة الملكية دورًا رئيسًا في هذا الصدد، إذ شهدت بناء مطار وجدة أنجاد، وخطوط سكك حديدية تربط الأجزاء الجنوبية من الجهة الشرقية بشمال البلاد، إضافةً إلى طريق سريع بين وجدة والناظور.
وقد تمّ إنجاز هذه المشاريع المهمة خلال السنوات الخمس عشرة الأولى من القرن الواحد والعشرين، بتكلفة ناهزت 10 مليارات دولار.
صحيحٌ أن الناظور مدينة ساحلية، إلا أنها تقع شرق التجمعات الساحلية الثلاثة للمغرب ولم تشهد تاريخيًا أي تنمية صناعية تُذكر.
بيد أن ذلك سيتغير على ما يبدو مع افتتاح مجمع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي من المزمع إنجازه بحلول العام 2024، وهو مشروع ضخم يضمّ ميناء ووحدات صناعية ولوجستية ومنطقة تجارة حرة، ويمتلك القدرة على تعزيز دمج المنطقة من خلال ربطها بالطرقات البحرية الدولية.
علاوةً على ذلك، من شأن قدرة الميناء على تخزين ما بين 1 و2 مليون متر مكعب من المنتجات البترولية المكرّرة أن يساعد المملكة على تعزيز سيادة الطاقة. حتى الآن، دفعت الثقة بالمشروع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية إلى استثمار 113 مليون يورو (119 مليون دولار)، إضافةً إلى حصوله على قرض، تمّ الإعلان عنه في كانون الأول/ديسمبر من العام 2022، بقيمة 100 مليون يورو (106 ملايين دولار) من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
تشمل مشاريع الدمج الأخرى سعي المغرب لأن يصبح مركزًا عالميًا لصناعة السيارات. ففي أيلول/سبتمبر من العام 2021، أعلنت الشركة المتخصصة في تكنولوجيا السيارات أبتيف (Aptiv) عن استثمار يناهز 30 مليون دولار لبناء “مصنع ضخم” لكابلات السيارات في وجدة. ومن شأن هذا المشروع أن يؤمن في البداية 3,500 وظيفة في المنطقة، وربما أكثر في وقت لاحق.
وفي حال أثبت المشروع نجاحه وتمكّن من جذب مزيد من الاستثمارات، قد يُنظر إلى الشركة على أنها لعبت دورًا ناشطًا في تحقيق طموح المغرب بأن يصبح مركزًا لتكنولوجيا السيارات.
وبينما لم تبدُ آفاق جذب الاستثمارات إلى الشرق مشجعة، بادرت الحكومة المغربية، بالتعاون مع شركاء دوليين، ببذل جهود لتعزيز التوظيف من خلال إرسال سكان المنطقة إلى أماكن أخرى للتدريب.
فعلى سبيل المثال، تمّ في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إرسال خمسين شابًا من الشرق إلى مصنع يازاكي في طنجة، المتخصص في كابلات السيارات.
واندرج ذلك في إطار مشروع REVIS، الرامي إلى “الحدّ من الهشاشة الاقتصادية لإرساء استقرار أكبر من خلال تطوير المهارات الصناعية والشراكة بين الشركات”.
أطلقت هذا المشروع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة المغربية، منها مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك).
ويشجّع توظيف المرأة والشباب في سياق التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تعزيز شراكات بين القطاعَين العام والخاص، وتنظيم ندوات جانبية بين الشركات التجارية.
الأكيد أن محاولات كسر الجمود الاقتصادي وخفض معدل البطالة في الشرق لم تحصل باعتماد نهج من القمة إلى القاعدة وحسب، بل يظهر ذلك في تبنّي صيغة تعاونية تتماشى مع نموذج الاقتصاد الاجتماعي التضامني. وتقدّم التعاونيات فرصًا لتوفير سبل عيش مستقرة ومستدامة للعمال، ولا سيما النساء اللواتي غالبًا ما يستثنين من المقاربات التي تنطلق من أعلى إلى أسفل، وتأمين وسائل تساعد السكان المحليين على تحقيق إيرادات.
وفي الوقت نفسه، يفسح التنظيم المؤسسي للتعاونيات وطابعها الاجتماعي المجال للحفاظ على الهيكليات المجتمعية التقليدية، ويحدّ بالتالي من احتمالات التفكك الاجتماعي في أعقاب التقدّم الاقتصادي.
وفي حالة المغرب، مكّنت التعاونيات أيضًا السكان المحليين من تعويض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لإغلاق الحدود بصورة دورية. فمنذ العام 2015، ارتفعت أنشطة القطاع التعاوني بنسبة 63.9 في المئة.
ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مكتب تنمية التعاون، المسؤول عن عمل التعاونيات، تضمّ الجهة الشرقية 5,517 تعاونية وتوظف 79,602 شخصًا.
وتشكّل الجهود المبذولة في القطاع الزراعي، بما فيها زراعة نخيل التمر وإكليل الجبل وإنتاج العسل، 64 في المئة من النشاط التعاوني في الجهة.
ونظرًا إلى ارتفاع عدد التعاونيات العاملة في القطاع الزراعي، سعت السلطات الجهوية إلى حماية المنتجات المحلية مثل التمور وإكليل الجبل والزيتون والعسل وتشجيعها. وركزت جهودها على رفع قدرة التعاونيات على بيع منتجاتها من خلال إنشاء قنوات تواصل بينها وبين الأسواق المحلية وحتى الأجنبية. وتوّجت هذه الجهود بإطلاق منصة ترويج المنتجات المحلية من الجهة الشرقية.
وتعزّز هذه المبادرة المهمة المعارف الجهوية وتسويق المنتجات المحلية وتصديرها من خلال إنشاء شبكة من العمليات الإدارية وغرف التبريد ووحدات التعبئة والتغليف وآليات النقل، وتؤدي بالتالي إلى بروز نوع من اتحاد تعاونيات.
مواجهة التحديات الثلاثة
بصرف النظر عن التقدّم المُحرز، تواجه عملية دمج المناطق الحدودية الشرقية في الاقتصاد الوطني تحديات معينة، حتى أنها ولّدت تحدٍّ خاصٍ بها. وتتمثّل التحديات الثلاثة الأكثر إلحاحًا في الوضع السياسي المتوتر وتجلياته في التشدّد المتزايد بضبط الأمن على الحدود، وعملية التصنيع غير المتكافئة، والظواهر المترابطة لتغيُّر المناخ والتصحّر.
لكن هذه التحديات مستقلة عن بعضها البعض ولا تتحرك معًا بتناغم. علاوةً على ذلك، لا تمتلك جميعها الأثر السلبي نفسه على الجهود المبذولة لتحويل هذه المناطق ودمجها في الاقتصاد الوطني، سواء من جهة الحكومة أو التعاونيات الوطنية.
مع ذلك، يعيق اجتماع هذه التحديات معًا هذا المسعى المبذول لإصلاح الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمناطق الحدودية الشرقية، وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى تعطيله.
أولى التحديات تتمثل في الوضع السياسي المتوتر بين المغرب والجزائر، التي لا تزال تداعياته تؤثّر على قدرة الحكومة المغربية على تحفيز اقتصاد شرق البلاد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بجذب الاستثمارات الكبرى التي تسعى إليها الرباط.
في هذا الإطار، تحاول الحكومة تجاوز التوترات الجيوسياسية، لكن لا يزال يُتوقّع أن تؤثّر سلبًا على آفاق نمو المغرب، كما ورد في تقرير صدر عن صندوق النقد الدولي في العام 2018.4 في المقابل، في حال تمّ تعزيز الاندماج والتعاون الإقليميين في شمال أفريقيا، قد يؤدي ذلك إلى تراجع تكاليف التجارة داخل المنطقة، وبالتالي إلى تعزيز تبادل رأس المال والعمالة، وجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمارات المباشرة الخارجية.
أما أكثر القطاعات تأثّرًا بالتوترات المتواصلة بين المغرب والجزائر فهما قطاعَي الطاقة والسياحة، اللذان يستفيدان بشكل كبير من وجود بيئة إقليمية متناغمة.
تمثّلت أوضح مظاهر الوضع السياسي المتوتر في التشدّد في ضبط أمن الحدود. ويشمل ذلك تدابير اتخذها المغرب والجزائر على السواء ردًّا على الاحتكاكات بين الدولتَين، وغالبًا ما انطوت على تقييد التبادلات التجارية عبر الحدود أو حرية مرور الأفراد، لكنها كانت مؤقتة في كثير من الأحيان.
على الرغم من ذلك، اكتسب التشدد في ضبط أمن الحدود طابعًا أطول أمدًا أو حتى دائمًا خلال السنوات القليلة الماضية. وينطبق ذلك بشكل خاص على هذه الحالة منذ أن قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط وأوقفت تشغيل خط أنابيب الغاز بين المغرب العربي وأوروبا في آب/أغسطس 2021.
وفي وقت سابق من العام نفسه، طردت الجزائر العمال الزراعيين المغاربة من بلدة العرجة الحدودية المتنازع عليها، وعلى الرغم من الدعوة إلى الحوار مع الجزائر، أعلن المغرب في العام 2022 أنه بصدد إنشاء منطقة عسكرية على الحدود. لا شكّ أن مثل هذه التدابير تؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات المحلية الحدودية.
التحدي الثاني يتمثل في أن تطبيق التغييرات الاقتصادية المترتبة على ذلك من دون تقييم أثرها على الحياة اليومية لسكان المجتمعات المحلية قد يؤدي إلى تفاوتات في التنمية، ويتسبب ببروز طبقية اجتماعية واحتكاكات.
وتبدو واضحة أساسًا المؤشرات الدالة على ذلك. ففي حين تؤدي مساعي الربط المتنامية إلى تحفيز التنمية وتحويل الشرق عمومًا من منطقة طرفية تاريخيًا إلى مركز اقتصادي، يصبح التصنيع والثروات المصاحبة على نحو متزايد متركزة في مدينتَي وجدة والناظور.
ولدى المدينتين تطلعات عالمية باعتبارهما صلة وصل بين الاقتصاد المحلي وسلاسل التوريد العالمية، وقد أطلق صعودهما الاقتصادي موجة من الهجرة الداخلية داخل الجهة الشرقية، حيث يغادر السكان الأرياف متجهين نحو وجدة والناظور، ما أدّى إلى بروز مناطق طرفية عدّة خاضعة إلى مراكز النفوذ. في المقابل، ساهم ذلك في بروز طلب جديد في وجدة والناظور على المشاريع السكنية وفرص العمل والمرافق التعليمية والصحية.
وعلى نحو مماثل، تتسبب الطرقات ومساعي الربط الجديدة في إعادة تشكيل بلدات أو حتى تهميشها، مثل بلدة بني درار، التي كانت تقف في صلب التبادلات الاقتصادية عندما كانت الدولة لا تزال متساهلة مع التهريب عبر الحدود.
هذه ليست عملية مفاجئة، فهي توازي ما حصل في الدول الأخرى التي شهدت تغييرات مماثلة.
صحيحٌ أن مساعي الربط ومشاريع البنى التحتية تسرع تدفق الأشخاص والبضائع ورؤوس الأموال بين مناطق محدّدة، إلا أنها تسهم في إقصاء المجتمعات المحلية غير القادرة على مواكبة الديناميكيات الجديدة، ما قد يؤدي إلى التفكك الجغرافي وبروز مناطق طرفية مهمشة داخل الجهة نفسها التي تشهد عمومًا ازدهارًا اقتصاديًا.
وفي شرق المغرب، يبقى أن نرى ما إذا كان مشروع الناظور غرب المتوسط سيوقف، وربما يعكس، التهميش الأخير الذي شهدته بلدة بني درار، نظرًا إلى قربها النسبي من الميناء ومنطقة التجارة الحرة المخطط لهما.
التحدي الثالث الذي تواجهه المناطق الحدودية الشرقية للمغرب فهو تغيّر المناخ.
يهدّد التصحّر وندرة المياه، اللذان يؤثران على وجه الخصوص على الجزء الجنوبي من المناطق الحدودية الشرقية، حركة السكان والإنتاج الزراعي في فجيج وتندرارة وبوعرفة، وغيرها.
ووفقًا لبيانات جمعها باحثون في جامعة محمد الأول في وجدة، انخفض منسوب المياه الجوفية لنهر العرجة، الذي يتدفق عبر بلدات عدّة في الجهة أو بالقرب منها، من 20 إلى 50 مترًا خلال العقد الماضي.
وفي فجيج، من المتوقع أن تنخفض احتياطيات المياه الجوفية بنسبة 38 في المئة بين العام الجاري والعام 2099، وقد يشكّل مثل هذا التغيير خطرًا على أنشطة الرعي والزراعة، التي تتمتع بحيز كبير من الاقتصاد المحلي.
وبهدف معالجة آثار تغيّر المناخ، عمدت الحكومة إلى تعزيز الحفاظ على المياه وتحسين أساليب الري. وقدّم مخطط المغرب الأخضر، الذي أُطلق في العام 2008، ونسخته الأحدث، “الجيل الأخضر 2020-2030″، خارطة طريق لتطوير إدارة الموارد المائية بشكل يحافظ على البيئة وممارسات زراعية أكثر كفاءة موجهة نحو التنمية الطويلة الأمد.
وفي تشرين الأول/أكتوبر من العام 2022، تمّ في إطار هذه الخطة توفير برنامج طوارئ للري لحوالى 400 مزارع، معظمهم يملكون حقول زيتون في الجهة الشرقية.
وعلى نحو مماثل، حيث لا تزال زراعة التمور المصدر الرئيس لكسب الرزق، وهو إلى حدّ كبير حال الأجزاء الجنوبية من الجهة الشرقية، أنشأت وزارة الفلاحة السدود وأنظمة إمدادات المياه، ما مكّن حوالي 1,500 مزارع في فجيج من الحصول على المياه بصورة منتظمة.
لقد تكيفت التعاونيات مع تغير المناخ، بحيث يركّز عدد كبير منها أنشطته على زراعة الزيتون واللوز وإكليل الجبل، بالتحديد من أجل ربحيتها واستدامتها. وقامت بتجميع مواردها، وإقامة شراكات تهدف إلى تقاسم المعدات والأدوات، وتوفير التدريب، وإنشاء مشاريع مشتركة. في هذا الإطار، تساعد الوكالات الدولية التعاونيات على أن تصبح أدوات للتنمية المحلية في المنطقة.
فعلى سبيل المثال، قدمت شراكة بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومنظمة العطاء المباشر (GiveDirectly) الدولية غير الحكومية، دفعات نقدية بلغ مجموعها 4 ملايين دولار إلى 1,093 تعاونية في جميع أنحاء المغرب، بما فيها عدد كبير من التعاونيات في الجهة الشرقية.
ومكّنت هذه الأموال التعاونيات، التي تواجه صعوبات نتيجة التضخم والصدمات الاقتصادية الأخيرة، من شراء المعدات والمواد الخام التي من شأنها أن تبقيها صامدة. وعلى الرغم من أن المرء يمكن أن يشكك في استدامة التحويلات النقدية، إلا أن هذه المبادرات تدعم في الوقت الراهن النموذج التعاوني، الذي أثبت بالفعل قيمته للجهة.
من الصعب توقّع التأثير المستقبلي للحدود على الاقتصاد المغربي، إلا أن مشروع الحكومة المغربية المستمر الرامي إلى دمج مناطقها الحدودية الشرقية يشير على ما يبدو إلى أن هذا التأثير سيستمر في التضاؤل. فشرق المغرب، الذي كان مهملًا فيما مضى بات أكثر ارتباطًا من ذي قبل بالمراكز الاقتصادية للبلاد وكذلك بسلاسل التوريد العالمية. وفي الوقت نفسه، تشهد المؤسسات التعاونية ازدهارًا.
اخيرا
ويبدو أن هذين الاتجاهين سيستمران، حتى لو تواصلت التوترات السياسية بين المغرب والجزائر، واستمر تغيّر المناخ في التأثير سلبًا بالبيئة المحلية.
لكن نوع التغييرات المجتمعية التي قد تحدثها المشاريع الاقتصادية شرق البلاد ليس واضحًا. وبهدف تفادي التفكك الاجتماعي ومشاعر الاستياء، وفي نهاية المطاف ردود فعل شعبية، لا بدّ من إشراك سكان الجهة الشرقية في عملية صنع القرار في إطار المبادرات الاقتصادية، ويفضّل أن يكون من خلال هيئات تمثيلية مُنتخبة.
ويتجلى ذلك إلى حدّ ما في التعاونيات، التي يؤثر أعضاؤها في الكثير من الأحيان على توجهها والمشاريع التي تتولّاها. لكن ذلك لا يتمتّع بأهمية تُذكر في مشاريع التصنيع من أعلى إلى أسفل التي تقودها الحكومة، والتي يُعد حجمها وتأثيرها هائلين، على الرغم من أن المكاسب التي تحققها قد لا توزع بشكل متساوٍ، الأمر الذي يُعتبر مثيرًا للقلق.
ومن أجل نجاح الجهود التي تبذلها الحكومة لإضفاء الطابع الصناعي على الشرق، لا بدّ من إشراك المناطق الجنوبية التي تهيمن فيها الأنشطة الزراعية وتُعتبر الأكثر تأثرًّا بتغيّر المناخ.
علاوةً على ذلك، يتعيّن على الحكومة ضمان إعادة توجيه الأرباح والمنافع الاقتصادية التي يتمّ تحقيقها بفضل هذه التغييرات الهيكلية شرق البلاد إلى المجتمعات المحلية في الجهة نفسها وإعادة استثمارها فيها.
المصدر: مؤسسة كارينغي للسلام الدولي